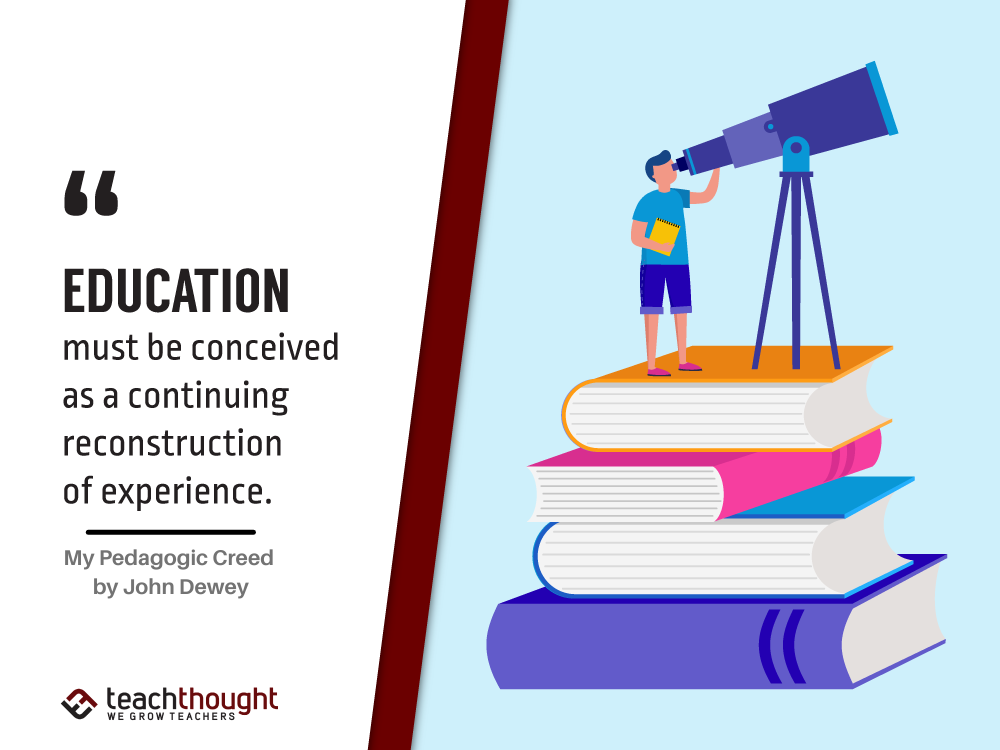عقيدتي التربويـة
جون ديوي
مجلّة School Journal، المجلد 54 (يناير 1897)
المقالة الأولى: ما هي التربية؟
أرى أن التربية عملية اجتماعية تبدأ عملياً منذ الولادة وتستمر في تشكيل قوى الفرد ووعيه وعاداته وأفكاره ومشاعره. عبر هذا التعلم غير الواعي يشارك الفرد في المخزون الفكري والأخلاقي الذي جمعته الإنسانية، فيصبح وارثاً لرأس مال الحضارة. حتى أشد أشكال التعليم رسوخاً وتقنية لا يمكنها الانفصال عن هذه العملية الأساسية إلا لتنظيمها أو توجيهها في اتجاه خاص.
التعليم الحقيقي ينبع من إثارة قوى الطفل بفعل متطلبات المواقف الاجتماعية التي يعيشها؛ فهذه المتطلبات تدفعه إلى العمل كعضو في كيان اجتماعي، وتخرجه من ضيق محاولاته وشعوره ليبدأ إدراك مصلحته ضمن مصلحة الجماعة. من ردود فعل الآخرين على أنشطة الطفل يتضح له المعنى الاجتماعي لتلك الأفعال، فتنعكس القيمة عليه وتتحول ألفاظه الأولى إلى لغة معبرة تُدخله في ثروةٍ مجمعة من الأفكار والمشاعر.
للتربية وجهان لا ينفصلان: النفسي والاجتماعي، وليس لأحدهما أن يُهمَّش دون أن يترتب على ذلك نتائج ضارة. الأساس نفسي: غريزات الطفل وقواه هي مادة التعليم ونقطة انطلاقه. إن لم ترتبط جهود المربّي بنشاط الطفل المستقل، تتحول التربية إلى ضغط خارجي قد يعطي نتائج سطحية لكنه لا يكون تربية حقيقية. وبغياب فهم البنية النفسية للطفل، يصبح العمل التربوي عشوائياً وقد يؤدي إلى احتكاك أو تفكك أو كبح طبيعة الطفل.
معرفة الظروف الاجتماعية وحالة الحضارة ضرورية لتفسير قوى الطفل: علينا أن نعيد غريزاته إلى سياقها الاجتماعي الماضي ونستشرف نتائجها في المستقبل. فمثالاً، فهمنا لتلعثم الطفل يعطينا قدرة على التعامل معه بوصفه بذرة لمحادثة اجتماعية مستقبلية.
العلاقة بين الجانبين عضوية: لا تُفهم القوة الحقيقية إلا إذا تصورنا وظيفة هذه القوة في العلاقات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه فإن التكييف الوحيد الممكن للطفل هو ذلك الذي يتيح له التسلط على قواه. في ظل الديمقراطية والصناعات الحديثة لا يمكننا إعداد الطفل لمجموعة شروط ثابتة؛ بل الهدف هو منحه القدرة على التحكم في نفسه، فإذا اتقن حواسه وأدواته وحُسّن حكمه وصُهِّرت قواه التنفيذية للعمل بكفاءة، سيكون قادراً على التكيّف مع مستقبل متقلب. لذلك يجب أن تبقى التربية متحوّلة إلى شروط نفسية دائمة: فهم قدرات الطفل، ميوله واهتماماته، وترجمتها إلى ما يمكن أن تخدمه اجتماعياً.
المقالة الثانية: ما المدرسة؟
أؤمن أن المدرسة مؤسسة اجتماعية بالأساس. بما أن التربية عملية اجتماعية، فالمدرسة هي شكل من أشكال الحياة الجماعية التي تركز المصادر والوسائل الأكثر فاعلية لإدخال الطفل في الموارد الموروثة للجنس البشري ولتوجيه قواه نحو الأهداف الاجتماعية.
التربية إذن هي حياة قائمة الآن، وليست مجرد إعداد للمستقبل؛ فالمدرسة يجب أن تمثل الحياة الراهنة للطفل بقدر ما تمثلها الأسرة أو الحي أو ساحة اللعب. التعليم الذي لا ينشأ عبر أشكال حياة جديرة بأن تُعاش لذاتها، يبقى بديلاً فقيراً يقيّد وينزع الحيوية.
بوصفها نمطاً مبسّطاً من الحياة الاجتماعية، ينبغي أن تَنبُع الحياة المدرسية تدريجياً من حياة المنزل، وأن تتابع الأنشطة المألوفة للطفل في بيته، وأن تُعيد تقديمها بطرق تسمح له بفهمها والاضطلاع بدور مناسب فيها. هذه الضرورة نفسية لأنها تضمن استمرارية نمو الطفل، واجتماعية لأنها تعمق قيم الحياة المنزلية التي نشأ فيها.
يفشل كثير من التعليم الراهن لأنه يتجاهل هذه القاعدة: يعتبر المدرسة مجرد مكان لتلقي معلومات أو حفظ دروس أو تكوين عادات تُقدَّم على أنها إعداد لشيء آخر بعيد. نتيجة ذلك لا تصبح تلك الأشياء جزءاً من تجربة حياة الطفل فتفقد قيمتها التربوية الحقيقية.
التربية الأخلاقية تتأسس على فكرة المدرسة كنمط حياة اجتماعية؛ أفضل تدريب أخلاقي هو ذلك الذي ينشأ من الدخول في علاقات صحيحة مع الآخرين ضمن وحدة عمل وفكر. أما نظم التعليم الحالية التي تهدم أو تهمل هذه الوحدة فتصعب أو تمنع التدريب الأخلاقي المنظم الحقيقي.
يجب أن تُحفَز أعمال الطفل وتُوجه عبر حياة الجماعة؛ وللأسف، في ظل الظروف القائمة يأتي الكثير من الحافز والسيطرة من المدرّس مباشرة لأن فكرة المدرسة كمجتمع متكامل مهملة. دور المدرّس إذن ليس فرض أفكار أو تشكيل عادات بالقسر، بل المشاركة كعضو في المجتمع لاختيار التأثيرات التي تؤثر في الطفل ومساعدته على الاستجابة الملائمة لها. يجب أن تنبع انضباط المدرسة من حياة المدرسة ككل، ويحدد المدرّس، استناداً إلى خبرة أوسع وحكمة أعمق، كيف يصل الطفل إلى قواعد الحياة. وكل مسائل التصنيف والترقية يجب أن تُحكم بمعيار واحد: ملاءمة الطفل للحياة الاجتماعية وكفاءته فيها. الاختبارات مفيدة إلى الحد الذي تقيس فيه هذه الملاءمة وتكشف المكان الذي يكون فيه الطفل أكثر فائدة وتلقياً للمساعدة.
المقالة الثالثة: موضوعات المنهج
أساس التركيز والتكامل في نمو الطفل هو حياته الاجتماعية؛ فالحياة الاجتماعية توفر الوحدة غير الواعية وخلفية كل مساعيه وإنجازاته. يجب أن تبرز مواضيع المنهج كتفرعات تدريجية من تلك الوحدة الأولية للحياة الاجتماعية. نفعل خطأً عندما نقدم الطفل فجأة إلى دراسات متخصصة مثل القراءة والكتابة والجغرافيا بمعزل عن حياته الاجتماعية؛ هذا يعيق طبيعة الطفل ويصعّب تحقيق أفضل النتائج الأخلاقية.
مركز التكامل ليس العلم وحده ولا الأدب ولا التاريخ، بل أنشطة الطفل الاجتماعية نفسها. العلم لا يجعل الوحدة بحد ذاته لأن الطبيعة، دون النشاط البشري، ليست وحدة بل مجموعة أشياء متنوعة؛ الأدب هو تعبير وانعكاس للتجربة الاجتماعية فله أن يأتي بعد التجربة وليس قبلها، وقد يصبح ملخّصاً للتوحيد. التاريخ مفيد تعليمياً كلما عرض صوراً من الحياة الاجتماعية والنمو ويجب أن يخضع لمرجعية الحياة الاجتماعية وإلا يُصبح ميتاً في الماضي البعيد.
الأساس الأولي للتربية هو قوى الطفل العاملة على الخطوط نفسها التي بنت الحضارة. والطريقة الوحيدة لجعل الطفل واعياً لإرثه الاجتماعي هي تمكينه من أداء أنواع النشاط الأساسية التي صنعت الحضارة. لذلك أؤمن بتركيز المنهج حول الأنشطة التعبيرية والبنائية: الطبخ، الخياطة، التدريب اليدوي… ليست دراسات ترفيهية إضافية، بل تمثل أشكالاً أساسية من النشاط الاجتماعي، ومن المرغوب أن يُقدَّم الطفل إلى المواد الرسمية من خلالها.
العلم ذو قيمة تربوية إلى الحد الذي يكشف المواد والعمليات التي تجعل الحياة الاجتماعية ما هي عليه؛ لكنه غالباً ما يُعرَض اليوم بصيغة موضوعية بحتة، كخبرة جديدة مستقلة عن خبرة الطفل السابقة. في الواقع، العلم أداة لتفسير وتنظيم الخبرة القائمة، ويجب تقديمه كآلية لتوضيح العوامل المتضمنة فيها وتزويد الطفل بأدوات للتحكم فيها بفعالية.
نفقد في كثير من الأحيان قيمة الأدب والدراسات اللغوية لأننا أزلنا ما هو اجتماعي. اللغة أداة اتصال أولاً وقبل كل شيء؛ حين تُعامل اللغة كوسيلة لمعرفة فردية أو للتباهي بما تعلمه المرء، تفقد دافعها الاجتماعي وغايتها.
لا توجد بالضرورة تسلسل صارم للدراسات في المنهاج المثالي؛ فالحياة تتضمن منذ البداية جوانب علمية وفنية وتواصلية. التقدّم الحقيقي ليس في تبدّل الموضوعات عبر الصفوف بقدر ما هو في نمو المواقف والاهتمامات تجاه الخبرة. وأخيراً، يجب أن تُفهم التربية كإعادة بناء مستمرة للخبرة؛ العملية والهدف هما أمر واحد. لو وضعنا هدفاً خارج التربية لحرمنها من كثير من معناها ودفعنا للاعتماد على مؤثرات خارجية زائفة في التعامل مع الطفل.
المقالة الرابعة: طبيعة المنهج
مسألة المنهج ترجع في النهاية إلى ترتيب نمو قوى واهتمامات الطفل. قانون تقديم المواد ومعالجتها موجود ضمن طبيعة الطفل نفسها. من معايير الروح التي ينبغي أن تحكم التعليم:
1) الجانب الفاعل يسبق الجانب المتلقّي في نمو الطفل: التعبير يسبق الانطباع الواعي، والنمو العضلي يسبق الحسي، والحركة تسبق الإحساس الواعي. الوعي ذو طابع حركي أو دافعي؛ الحالات الواعية تميل إلى الإسقاط في الفعل. إهمال هذا المبدأ يسبب هدر الوقت والجهد حين يُجبر الطفل على موقف سلبي مُستقبِل لا يسمح له باتّباع قانونه الطبيعي فتنشأ الاحتكاكات والهدر.
الأفكار تنشأ أيضاً من الفعل وتكون من أجل ضبط الفعل بصورة أفضل؛ ما نسمّيه العقل أساسه تنظيم الفعل الفعّال. محاولة تنمية قوة العقل أو الحكم دون ربطها باختيار وسائل العمل وترتيبها خطأ جوهري. لذلك كثيراً ما نُقدّم للطفل رموزاً تعسفية؛ الرموز ضرورية لكنها أدوات لتقليل الجهد، وعندما تُعرض منفردة تصبح حزمة أفكار بلا معنى مفروضة من الخارج.
2) الصورة الذهنية أداة عظيمة في التعليم: ما يختزنه الطفل من أي مادّة هو الصور التي يشكلها عنها. لو استُنفِدت ثلثا طاقاتنا الحالية الموجهة لجعل الطفل يتعلّم أموراً معينة في تدريب الطفل على تشكيل صور ذهنية واضحة وحية ومتنامية، لتسهّل التعليم إلى حد بعيد.
3) الاهتمامات علامات على نشوء قوى؛ إنها دلائل على قدرات فجرية. رصد الاهتمامات بمنتهى العناية أمر بالغ الأهمية للمربّي. تُظهر الاهتمامات حالة التطور التي بلغها الطفل وتنبئ بالمرحلة التي على وشك أن يدخلها. لا بد من الملاحظة المستمرة والمتعاطفة لاهتمامات الطفولة ليدخل البالغ عالم الطفل ويرى ما يهيّأه وكيفية العمل معه بأكثر نفع وإنتاجية.
لا ينبغي تدليل الاهتمامات ولا قمعها: قمعها يعني إحلال البالغ محل الطفل وإضعاف الفضول والمبادرة، أما التدليل فيقود إلى استبدال العابر بالدائم؛ الاهتمام دائماً علامة على قوة باطنية والمهم اكتشاف تلك القوة. التدليل يفشل في اختراق السطح ويستبدل المزاج والهوى بالاهتمام الحقيقي.
4) المشاعر انعكاس للأفعال: محاولة إثارة المشاعر بمعزل عن أنشطتها المقابلة تخلق حالة عقلية مريضة. إذا أمكنا إرساء عادات صحيحة للفعل والفكر في مراجع الخير والحق والجمال، فإن المشاعر ستعتني بنفسها إلى حد كبير. بجانب الجمود والرتابة، لا يهدد تعليمنا من شرّ أعظم من الميوعة العاطفية التي تنجم عن فصل الشعور عن الفعل.
المقالة الخامسة: المدرسة والتقدّم الاجتماعي
أعتبر التعليم الوسيلة الأساسية للتقدم والإصلاح الاجتماعي. الإصلاحات المبنية على سنّ القوانين أو التهديد بالعقاب أو تغييرات إجرائية سطحية تظل عابرة وعديمة الجدوى. التعليم هو تنظيم عملية الانضمام إلى الوعي الاجتماعي، وتكييف نشاط الفرد على أساس هذا الوعي هو السبيل الأكيد لإعادة البناء الاجتماعي.
هذا التصور يجمع بين المثاليين الفردي والاجتماعي: فردي لأنه يعترف بأن تكوين الشخصية الصالحة هو أساس العيش السليم، واجتماعي لأنه يرى أن هذا التكوين لا ينجز بمجرد الوعظ الفردي بل بتأثير شكل معيّن من الحياة المؤسسية أو الجماعية على الفرد، وأن الكائن الاجتماعي عبر المدرسة كعضو فيه قد يحدد النتائج الأخلاقية.
في المدرسة المثالية يتصالح المثاليان الفردي والمؤسساتي. وجوب المجتمع تجاه التربية هو، إذن، واجبه الأخلاقي الأسمى. يمكن للمجتمع أن ينظم نفسه بالقانون والعقاب أو بالنقاش، لكن عبر التعليم يمكنه صياغة أغراضه وتنظيم موارده بدقة واقتصاد وتحريك نفسه نحو اتجاه مرغوب بوضوح.
حين يعترف المجتمع بهذا الإمكان ويتحمل الالتزامات المصاحبة، لا يمكن أن نتصور مقدار الوقت والاهتمام والمال الذي سيوفره للمربّي. من واجب كل معني بالتربية أن يطالب باعتبار المدرسة الأداة الأهم والأقدر على التقدّم والإصلاح الاجتماعي، ليوقظ المجتمع على قيمة المدرسة ويحفزه على تزويد المربّي بما يكفيه لأداء مهمته.
هذا الفهم للتربية يجسد أكثر اتحاد ممكن بين العلم والفن في التجربة الإنسانية؛ فن تشكيل القدرات البشرية وتكييفها للخدمة الاجتماعية فنّ سامٍ يستدعي أفضل الفنانين: لا يوجد حدّ للإدراك أو الشفقة أو البراعة التنفيذية التي يخدمها هذا العمل.
مع نمو العلوم النفسية والاجتماعية يمكن توظيف كل الموارد العلمية لأغراض التربية، وعندما يتحدّ العلم والفن بهذا الشكل سيبلغ الدافع الأسمى للفعل الإنساني، وتُثار أنبل دوافع السلوك البشري، وتُضْمَن أفضل خدمة تُمكن أن يؤدّيها الإنسان.
أخيراً، المدرّس لا يعمل فحسب على تكوين أفراد، بل في تشكيل الحياة الاجتماعية الصحيحة. يجب على كل مدرس أن يعي كرامة مهنته؛ فهو خادم اجتماعي مُخصّص للحفاظ على النظام الاجتماعي السليم وتأمين النمو الاجتماعي الصحيح. هكذا يكون المدرّس دوماً نبياً للحق ومانحاً طريق المملكة الحقيقية.