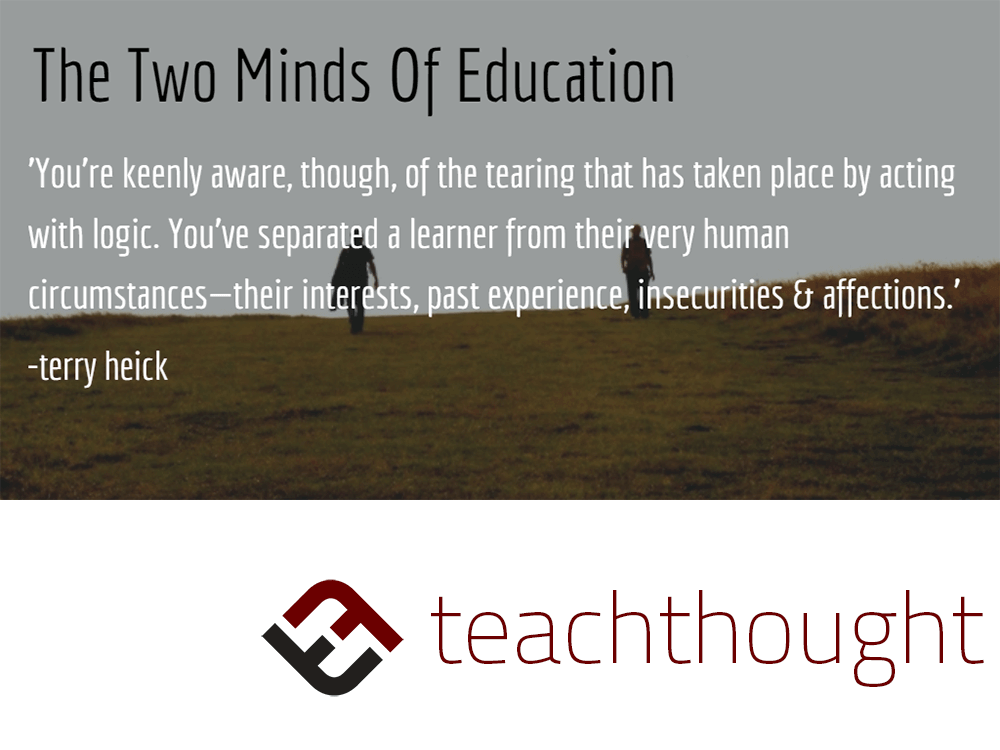بقلم تيري هيك
في مقالة بعنوان «عقليْن»، يقدّم ويندل بيري تصوّرين مختلفين للفكر: عقل عقلاني قائم على المنطق والقياس والاستنتاج، وعقل متعاطف يغذّيه المودّة والانفعال والانطباعات البشريّة — الغرائز، التبجيل، الفرح، والإيمان. هذان النمطان يتصارعان للظهور في سلوكنا الجماعي، إذ يسعى كل منهما للتحكّم في أفعالنا وقولنا.
يفصّل بيري هذا التمايز بوضوح: العقل العقلاني يحركه الخوف من الضلال ومن الخطأ؛ غايته استبعاد كل ما لا يمكن إثباته تجريبيًا أو قياسيًا. أما العقل المتعاطف فدافعه نوع آخر من الخوف: خوف الإهمال، وخوف أن نكون غير محبين؛ غايته أن تكون حريصًا على ما هو حاضر، وألا يترك شيئًا خارج الاعتبار.
لا عجب أن هذا الانقسام ينعكس في مجال التعليم. كمعلمين أو إداريين أو مصمّمي مناهج تواجهنا ثنائيات متضاربة: الحاجة لأن نكون عقلانيين ومنهجيين واستراتيجيين تصطدم بتعقيد السياق والحجم الهائل للمهمة — تعليم عشرات الطلاب ما يلزمهم من معارف ومهارات في مجال معيّن.
يُطلب منا أن نكون «قائمين على البيانات»، أي أن نصمّم تجارب التعلم بناءً على استنتاجاتٍ مستخرجة من قياسات ومسوحات. نسأل أنفسنا لماذا هذه الاستراتيجية التدريسيّة؟ ولماذا هذا الشكل من التقييم؟ ولماذا العمل الجماعي في هذا الزمن من الحصة وليس في ذاك؟ تلك أسئلة العقل العقلاني.
لكن العقل العقلاني، على الرغم من فاعليته، هو خادم لفكرٍ آخر: إنه يستثارة من انعدام الأمن الذي نعيش معه حين ندرك ضخامة المهمة واستحالتها في آنٍ واحد. فبدل أن نعالج طالبًا لا يجيد القراءة وطلابًا موهوبين فنيًا وآخرين مفتقدين للدعم العاطفي، نلجأ إلى التحليل والتصنيف. نقرأ معايير الأداء ونفحص الرسوم البيانيّة ونقتبس استراتيجيات من كتابات مارزانو وهاتي. نستمع إلى الزملاء والمدرّب التربوي، ثم ندرّس ونقيس ونعيد التدريس ونقيّم ونقوّي وننتقل إلى الوحدة التالية.
لكننا ندرك، ربما بوضوحٍ مؤلم، الانقسام الذي أحدثته هذه الممارسات: لقد فصلنا المتعليمن عن ظروفهم الإنسانيّة — اهتماماتهم، خبراتهم السابقة، انعدام الأمان الذي يعانون منه، ومودتهم. فصلنا المحتوى الأكاديمي عن المخطط الذهنيّ الأصلي لديهم؛ الكفاءة عن الفضول؛ المفاهيم العلمية عن التطبيق العملي للعلم؛ مستوى القراءة عن حبّ القراءة.
العقل العقلاني يميل بطبيعته إلى استبعاد الفضول والحبّ والمودّة والفرح لأنها تبدو «لاعقلانية». نعيش في عصر المعلومات الذي ورث أثر عصر التنوير؛ بطبيعته، لا يحتمل المنهج القياسي والتجريبي التجريد والإنسانيّة لأنهما يهزّان توازن آلات القياس والمنطق.
إذًا يتطلّب منا هذا الواقع تعديلًا في موقفنا: أن نتوقّف عن العناد إزاء ما نراه يتنامى لدى طلابنا — اللامبالاة، وسهولة التشتيت، وضحالة الانخراط. كمهنة، أصبحنا مهووسين بخطاب البحث العلمي والقابل للقياس، متخلّصين من «خرافات» مثل الصبر ومعرفة الذات والمجتمع. وتركنا حمْل التصادم بين السياسات أو المعايير الخالية من الحياة والمدارس إلى المدرّسين وحدهم.
لكن إذا أردنا أن نكون «مراعين لما هو حاضر» وأن «لا نغفل شيئًا» بالمعنى الذي يقترحه بيري، يتضح لنا أن العقلانية المحضة ليست عقلًا بحد ذاتها بقدر ما هي ردّ فعل فطري على ضخامة مهمتنا.
التحدّي، إذًا، هو أن نرتقي بالتدريس إلى ما وراء التجزيء عبر زواجٍ واعٍ بين العقل العقلاني والعقل المتعاطف. أن نتبنّى موقفًا شموليًا يقترن فيه التفكير الاستراتيجي بالاعتبار الإنساني: نستخدم البيانات لنخطّط، لكننا لا نغفل عن الفضول والحنان والاحترام المتبادل. أن نصرّ، دومًا، على ألا نلجأ إلى العقلانية وحدها ولا إلى التعاطف بمعزلٍ عن المنهج، بل نعمل كـ«مدرّسين كليّي الأبعاد» في كل تفاعل وتحليل نقدي نقديٍّ نقديّ مع طلابنا، وبذلك نُعلّمهم ممارسة إنسانية جوهرية.
أن نكون معلمين كاملين يعني أن نربط المعرفة بالإنسانة، والمعايير بالظروف، والقياس بالرحمة. بهذا نؤسّس لتعليم لا يكتفي بانتاج متقنين فحسب، بل يَصنع بشراً قادرين على التفكير، والشعور، والتصرّف بكرامة، ومسؤولية.