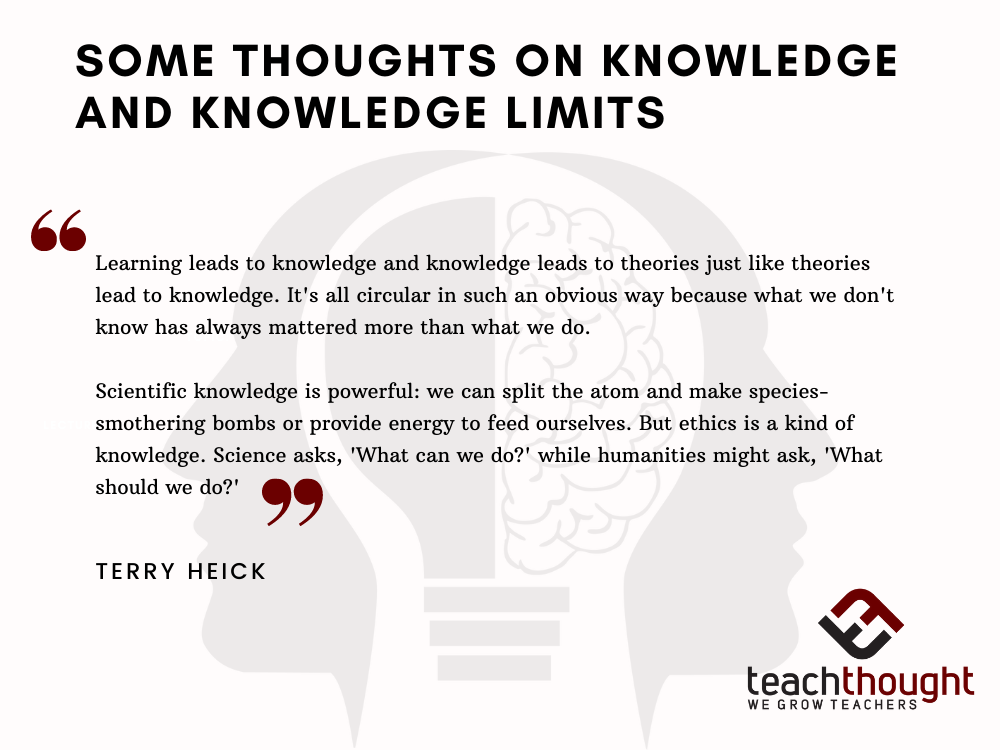المعرفة محدودة.
وعجزات المعرفة لا حدود لها.
معرفة شيء ما — أو بكل الأشياء التي لا نعرفها مجتمعَة — هي شكل من أشكال المعرفة نفسها.
تتعدد أشكال المعرفة؛ ولتخيلها يمكننا التفكير بوزن مادي: الوعي الضبابي شكل «خفيف» من المعرفة: وزنٌ واحد، شدة قصيرة، وإحساس طارئ. ثم يأتي وعيٌ أكثر تحديدًا، ثم تصورات وملاحظات، وخطوة أبعد قد يكون «المعرفة» بقدر ما هي أكثر تجسيدًا. وما بعد المعرفة يكون الفهم، وما بعد الفهم يكون الاستخدام، وما بعد الاستخدام تظهر سلوكيات معرفية أكثر تعقيدًا: الجمع والتعديل والتحليل والتقويم والنقل والابتكار، وهكذا.
كلما تحركنا من اليسار إلى اليمين على هذا الطيف الافتراضي، تصبح «المعرفة» أثقل وتُعاد تسميتها كوظائف معرفية ذات تعقيد متزايد.
ومن المهم أيضًا أن نوضح أن كل واحد من هذه الأفعال يمكن أن يكون سببًا ونتيجةً للمعرفة، وغالبًا ما ينظر إليها كمهارات إدراكية مستقلة عن «المعرفة» بحد ذاتها. فـ«التحليل» عمل فكري يمكن أن يؤدي إلى معرفة أو يحسنها، لكننا لا نعد التحليل شكلاً من أشكال المعرفة بنفس الطريقة التي لا نعد الركض شكلاً من أشكال «الصحة». ولحظةً، يمكننا أن نقبل هذه التفريقات.
هناك تصانيف كثيرة تحاول ترتيب هذه المستويات هرميًا، لكنني أفضّل رؤيتها طيفًا تسكنه أشكال مختلفة. ماهية هذه الأشكال وأيها «أعلى» أقل أهمية من حقيقة وجودها، وبعضها يُعدّ بكل جدارة «أكثر تعقيدًا» من غيره.
ما لا نعرفه كان، ولا يزال، أكثر أهمية مما نعرفه.
هذا قضائي ورأيي؛ قد يراه البعض مسألة ذاتية أو معاني لفظية أو حتى هوسًا دقيقًا، لكن للاستفادة من معرفتنا يجب أن نكون واعين بما لا نعرفه — ليس بمعنى أننا نمتلك تلك المعلومات، لأن لو كنا نملكها فلن نحتاج إلى الإدراك بأنها مفقودة.
دعني أبدأ من جديد.
المعرفة تدور حول العجز. علينا أن نكون واعين بما نعرفه وكيف نعرف أننا نعرفه. وبـ«واعٍ» أعني هنا امتلاك شيءٍ ما في شكلٍ دون جوهره أو مضمونه: معرفة غامضة.
بترسيم حدّ لما تعرفه (كمية) ولكيفية معرفتك له (جودة)، فإنك لا تصنع مجرد قائمة مهام لاكتساب معرفة مستقبلية، بل تتعلم أيضًا أن تستعمل ما تعرفه الآن بكفاءة أكبر.
بعبارة أخرى، يمكنك أن تصبح أكثر ألفة بحدود معرفتك، وربما لا تَـ«تعرف»ها تمامًا، لكن يصبح ذلك منصة رائعة لبدء استعمال ما تعرف. أو لاستعماله جيدًا.
كذلك يساعدك هذا في فهم حدود المعرفة عموماً، لا حدود معرفتك فحسب. يمكننا أن نسأل: ما الذي هو قابل للمعرفة؟ وهل هناك أشياء لا يمكن معرفتها؟ وما الذي نعرفه الآن كنوعٍ من البشرية وكيف وصلنا إلى معرفته؟ ومتى كنا لا نعرفه، وماذا كان شعور عدم المعرفة؟ وما أثر عدم المعرفة، وما أثر وصولنا إلى المعرفة؟
كمثال تشبيهي، تخيّل محرّك سيارة مفككًا إلى مئات القطع. كل قطعة تُعدّ قطعة معرفة: حقيقة، نقطة بيانات، فكرة. قد تكون كل قطعة نظامًا صغيرًا بحد ذاتها—كصيغة رياضية أو منظومة أخلاقية—تؤدي وظيفة مفيدة منفردة وتصبح أكثر فائدة عندما تُدمج مع قطع أخرى، وتزيد فائدتها بشكل أسّي حين تُضم إلى أنظمة معرفية أوسع.
إذا استطعنا إجراء ملاحظات لنجمع قطع المعارف، ثم نبني نظريات قابلة للاختبار، ثم نُشتق قوانين من تلك النظريات، فإننا لا نخلق المعرفة فحسب، بل نعمل على تقليم ما لا نعرفه. أو ربما هذا تشبيه غير دقيق: إذ أثناء إلقاء الضوء على المجهول نصنع آلافًا من القطع والنظم والفرضيات الممكنة، وما إلى ذلك.
عندما نصبح على الأقل واعين بما لا نعرفه، تترسخ تلك الفجوات داخل نظام معرفي. لكن هذا الترسخ والسياق والتأهيل لا يحدثان حتى تدرك ذلك النظام — ما يعني أن المعرفة، بالنسبة لمستعمليها (أنت وأنا)، تُميّز بما هو معروف وما هو غير معروف — وأن المجهول دائمًا أقوى مما هو معلوم.
اذهب مع هذا الافتراض الآن: أي نظام معرفي مركب من عناصر معروفة وغير معروفة — من معرفة ومن نقائص معرفية.
مثال لشيء لم نكن نعرفه
لنجعل الأمر أكثر ملموسية. عندما تعلمنا عن الصفائح التكتونية، فتح ذلك الباب أمام استخدام الرياضيات لتوقّع الزلازل أو تصميم آلات تتنبّأ بها. بتطوير نظريات تدور حول انزياح القارات اقتربنا تدريجيًا من مفهوم الصفائح التكتونية، لكننا لم نكن «نعرفه» بالضرورة. كمجتمع، قد نملك الاعتقاد بأن تعلم شيء يقودنا إلى تعلم أشياء أخرى، وقد نشتبه أن انزياح القارات سيؤدي إلى اكتشافات لاحقة، لكن بينما الصفائح التكتونية كانت قائمة بالفعل، لم نكن قد عرّفنا أو كشفنا عملياتها، فكانت بالنسبة لنا غير معلووم حتى حضر لها اسمٌ ومجموعة من الأدلة.
المعرفة غريبة بهذه الطريقة: حتى نعطي شيئًا اسماً — سلسلة من الرموز نستعملها للتعريف والتواصل والتوثيق — نميل لاعتباره غير موجود. في القرن الثامن عشر، حين بدأ الفلاح الإسكتلندي جيمس هاتون في تقديم حجج علمية متسقة حول تضاريس الأرض والعمليات التي تشكلها وتغيّرها، ساهم في ترسيخ الجيولوجيا الحديثة كما نعرفها. وإن كنت تؤمن بأن الأرض عمرها ستة آلاف سنة فقط بينما العلم يقول إنها مليارات السنين، فلن تبحث عن أو تُكوّن نظريات عن عمليات تمتد لملايين السنين.
إذن المعتقد واللغة والنظريات والجدال والدلالة والفضول والتحقيق المستمر جميعها مهمة. وكذلك التواضع. يبدأ التحول عندما تسأل عما لا تعرفه: فيتحول الجهل إلى نوعٍ من المعرفة. عند حسابك لنقائص معرفتك، فإنك تؤشرها — إمّا كأمور لا يمكن معرفتها، أو غير معروفة حاليًا، أو ما ينبغي تعلمه. تتوقف عن طمس الأشياء، وتصبح عملية إدراك وتحقيق ذاتي.
التعلّم.
التعلّم يقود إلى معرفة، والمعرفة تقود إلى نظريات، والنظريات تقود إلى معرفة. كل شيء دائري بطريقة واضحة لأن ما لا نعرفه كان دومًا أكثر أهمية من ما نعرفه. المعرفة العلمية قوية: نستطيع تقسيم الذرة وصنع أسلحة مدمرة أو توفير طاقة تغذينا. لكن الأخلاقيات نوع من المعرفة أيضًا. العلم يسأل: «ماذا يمكننا أن نفعل؟» بينما تسأل العلوم الإنسانية: «ماذا ينبغي أن نفعل؟»
الفائدة السائلة للمعرفة
عاود إلى تشبيه المحرّك غير المجمّع. كل قطع المعرفة مفيدة بحد ذاتها، لكنها تصبح أكثر فائدة بشكل أسّي عندما تُرتب وتُدمج بترتيب محدد لتنتج محرّكًا يعمل. ضمن هذا الإطار، كل الأجزاء لا قيمة لها عمليًا حتى يُحدّد أو يُنشأ نظام معرفي (مثل محرك الاحتراق) ويتم تشغيله، حينها تصبح كل القطع حرجة وتبدو عملية الاحتراق كنوع من المعرفة البسيطة.
خذ نفسًا؛ المعرفة تدور حول العجز. إن كان لدينا مجموعة قطع محرك غير مجمّعة وقطعة رئيسية مفقودة، فلن نستطيع بناء المحرك. هذا مقبول إن كنت تعرف أن القطعة مفقودة. أما إن كنت تظن أنك تعرف ما تحتاجه، فلن تبحث عن القطعة وستظل غافلًا عن إمكانية وجود محرك صالح. وهنا جزئيًا يكمن سبب تفوّق المجهول على المعلوم.
كل ما نتعلمه يشبه وضع علامة على خانة: نُقلّل عدم اليقين الجماعي بدرجات صغيرة. خانة واحدة أقل غير معرفة.
لكن حتى هذا وهم لأن الخانات لا تُستنفد أبدًا فعليًا: نُعلّم خانة فتظهر لنا 74 خانة جديدة؛ إذًا لا يتعلق الأمر بالكمّ بقدر ما يتعلق بالكيف. خلق معرفة يولد معرفة أُخرى بتسارع.
تأطير نقائص المعرفة يؤهل مجموعات المعرفة الموجودة. أن تعرف هذا يعني أن تكون متواضعًا؛ التواضع هو أن تعرف ما تعرفه وما لا تعرفه، وما كنا نعرفه سابقًا وما كنا نجهله، وماذا فعلنا بكل ما تعلمناه. هو أن تعلم أن اختراع أدوات لتخفيف العمل نادرًا ما يخفف العمل؛ بل ينقله ويُحوّله.
هو أن تعلم أن القِلّة من «الحلول الكبيرة» للمشكلات الكبرى لأن هذه المشكلات نفسها نتاج فشلٍ فكري وأخلاقي وسلوكي لا يُعدّ. تأمل اكتشاف «الطاقة النووية النظيفة» في ضوء تشيرنوبيل والتسمّم الذي أضافته إلى بيئتنا. ماذا لو استبدلنا مهرجان المعرفة بمهرجان الفعل وتأملنا آثاره قصيرة وطويلة الأمد؟
التعلّم يدفعنا عادة إلى السؤال: «ماذا أعرف؟» وأحيانًا: «كيف أعلم أني أعرف؟ هل هناك دليل أفضل يؤيد أو يدحض ما أعتقد أني أعرف؟» وهكذا.
لكن ما غالبًا ما نفشل في سؤاله عند تعلم جديد هو: «ما الذي ما زلت أفتقده؟» ماذا قد نتعلم بعد أربع أو عشر سنوات، وكيف يمكن لتلك التوقّعات أن تغيّر ما أظنه معرفيًا الآن؟ نسأل: «الآن بعد أن علمت، ماذا الآن؟»
أو بالأحرى، إذا كانت المعرفة نوعًا من الضوء، كيف أستعمل هذا الضوء مع الإحساس الضبابي بما يقبع خارج هامشه — مناطٍ لم يضيئ بعد؟ كيف أعمل من الخارج إلى الداخل، مبتدئًا بكل الأشياء التي لا أعرفها، ثم أتجه نحو الداخل حيث يصبح ما أعرفه أكثر وضوحًا وتواضعًا؟
نقص المعرفة المدروس هو نوع مهيب من المعرفة.