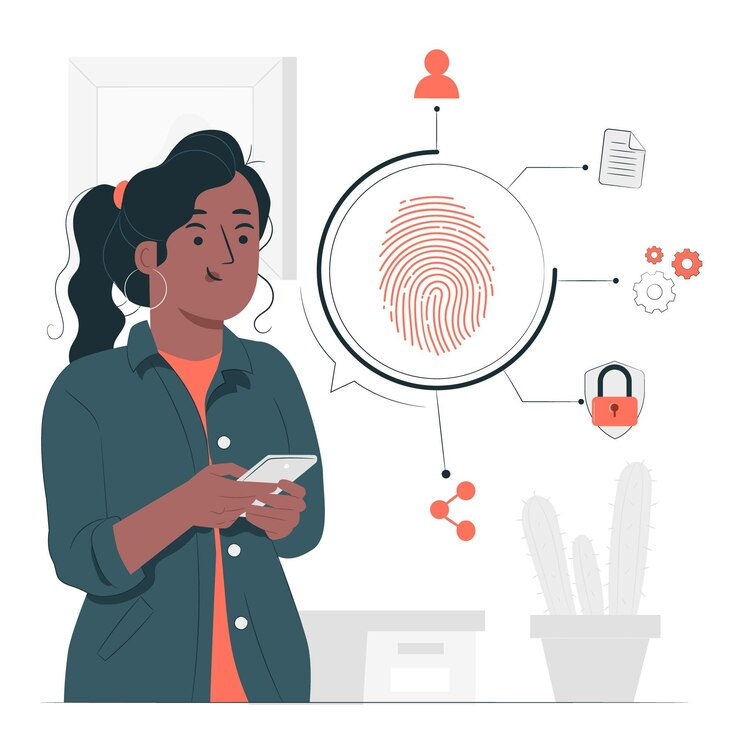القراءة والكتابة في القرن الحادي والعشرين: رؤية معاصرة للميديا والمناهج
في عصر تتشابك فيه الوسائط المادية والرقمية شبكاً كثيفاً، لم تعد القراءة كما كانت في القرون الماضية؛ فهي الآن عملية متسلسلة ومتشابكة تمتد عبر تويتر والروايات، بين القصائد والخرائط الزمنية التفاعلية، بين اللوحات والـغرافيتي، وبين الخطب وفيديوهات يوتيوب. داخل هذا الوفرة الإعلامية، يطرح سؤال جوهري: كيف يبدو القارئ المعاصر في القرن الحادي والعشرين؟
وسائط الإعلام: فن وعلم
الميديا، أو الوسيط الإعلامي، هي ببساطة وسيلة مقصودة لتوصيل فكرة أو تصور. بالتالي، تُعد التغريدة والرواية وملف الفيديو والشعر جميعها أشكالاً من الميديا. الاختلاف بين هذه الأشكال ليس جوهرياً فقط في الشكل، بل في الغرض والجمهور، في المدة والشدة، النبرة والبنية، وفي عناصر مرئية وخفية كثيرة يمكن للمصمم الإعلامي أن يغيّرها ويستثمرها.
التحول المركزي الذي يفرضه منهج القراءة والكتابة المعاصر هو تغيير منظورنا تجاه الميديا: ألا ننظر إليها كمجرد نصوص كلاسيكية تُدرس منفصلة، بل كمنظومات قابلة للدمج والتكييف في سياقات جديدة. الميديا كانت، وستظل، محورياً في مناهج الأدب واللغة. لكن علينا أن ننتقل من اعتبار العمل الأدبي كمركز مطلق إلى رؤيته كعنصر واحد في نسيج غني من الوسائط.
الميديا كمخطط ذهني (سكيما)
مفهوم السكيما يشير إلى الإطار المعرفي الذي نملكـه في أذهاننا ليسهل علينا فهم المعلومات الجديدة، أو ما يمكن تسميته بـ«المخزون المعرفي السابق». نربط الأفكار الجديدة بما نعرفه عبر المقارنة والتصنيف والربط والتمييز. بذلك، يمكن لعمل بسيط أو نص مبسّط أن يؤسس سكيما تساعد القارئ على فهم نصوص أعمق وأكثر تعقيداً لاحقاً. لهذا السبب، عندما نُدرّس الأدب أو اللغة، فإننا لا نطلب من المتعلمين القفز قفزات بعيدة جداً دون أن نوفر لهم عناصر ربط تمكّنهم من النقل المعرفي.
نقل المهارات والسياقات
التطبيق الناجح للمهارات المعرفية لا ينتقل دوماً بسهولة بين سياقات بعيدة؛ كما أشار باير في كتابه حول تعليم التفكير، فالممارسة الأولى ترتبط غالباً بالسياق الذي ظهرت فيه، ولذا ينبغي تعليم النقل (transfer) بشكل صريح ومنهجي. بدل أن نُجبر الطلاب على إعادة تغليف ما يتعلمونه بطريقة غريبة عن محيطهم الإعلامي اليومي، لِمَ لا نبدأ من وسائطهم الأصلية؟ النصوص الكلاسيكية مثل موبي ديك ليست بلا قيمة — بل هي غنية بمواضيع ذات صلة — لكن علينا أن نُعيد إدخالها إلى ميدان متكامل من الوسائط بحيث تُصبح قابلة للفهم والارتباط بالنسبة لجمهور معاصر.
التقنية: أداة لا بد أن تُخدَم، لا أن تُعبد
التطور التكنولوجي هو ما سمح بتولّد أشكال جديدة من الميديا؛ لكنه يبقى أداة. إغراق الصفوف بتكنولوجيا بحد ذاتها لا يكفي، كما أن رفضها يقصينا عن تجربة ثقافية مهمة. المطلوب هو تصميم معرفي وإبداعي يقدّم العمل الذهني والتصميم فوق بريق الأداة. لو اختفت التكنولوجيا غداً، لزم منا أن نعيد تصميم المناهج بطرق تحتفظ بالأصالة والجدوى؛ لكن اليوم نعلّم عبر التكنولوجيا لأن المتعلمين يستخدمونها في حياتهم اليومية — وهذا يقودنا إلى ضرورة ربط تعليمنا بسكياماتهم الإعلامية.
إعادة التفكير في الغرض من منهج اللغة
الهدف ليس خداع الطلاب ليتعلّموا ما نريد نحن، بل تعليم ما يهم فعلاً: قراءة الميديا وفهم مقصدها وبنيتها، التعرّف على الجمهور والغاية، تحديد الأطروحة وتطويرها، اختيارات اللغة، النبرة والجوّ — كل ذلك عناصر أدبية كلاسيكية يمكن تدريسها عبر ميديا معاصرة ومتكاملة. التعليم الفعال يدمج القديم بالجديد، ويستخدم مشاريع مبنية على حل المشكلات، ويصنع بيئات مركزة على الميديا حيث تبدو الصلة فورية، ويصير النقل المعرفي مستداماً.
خلاصة: نحو أصالة تعليمية تضع المتعلم في المركز
معلّم اللغة في القرن الحادي والعشرين لا يتبنّى التكنولوجيا بعينها ولا يهمل شكسبير؛ بل يبحث باستمرار عن الأصالة في المناهج. هو يدمج الوسائط القديمة والحديثة بطرق مبتكرة ليحوّل المتعلم من مجرد متلقٍ سلبي إلى فاعلٍ ناقدٍ ومراقبٍ لعملياته التعلمية، مستخدماً المعلومات على نطاق عالمي. حين ننجح في ذلك، تتغيّر المدرسة من فضاء جامد إلى منظومة مرنة تدعم تطور المتعلمين لتصبح لديهم كفاءة إعلامية — أي فضولية ومتمكنة من قراءة ومعالجة المعلومات.
أخيراً، كثيرٌ ما نغفل المتعلم وسياقه الأصلي في جدل المحتوى مقابل المهارات أو الكلاسيكي مقابل المعاصر. دور اللعب والتعلّم غير الرسمي قوي وموهوب في تجديد التعليم العام للقراءة والكتابة، ويستحق أن نمنحه مساحة استراتيجية في جهودنا الإصلاحية. حريّ بنا أن نبني مناهجٍ تكرّس هذا التوجه وتفتح المجال أمام متعلمين قادرين على الاستفادة من ثراء الميديا في عالم اليوم.حقيقه
ملاحظة: الصور ونسبتها للمصورين على فليكر استُخدمت كمراجع بصرية ضمن النسق التعليمي، دون أن تخلّ بالمحتوى النصي.