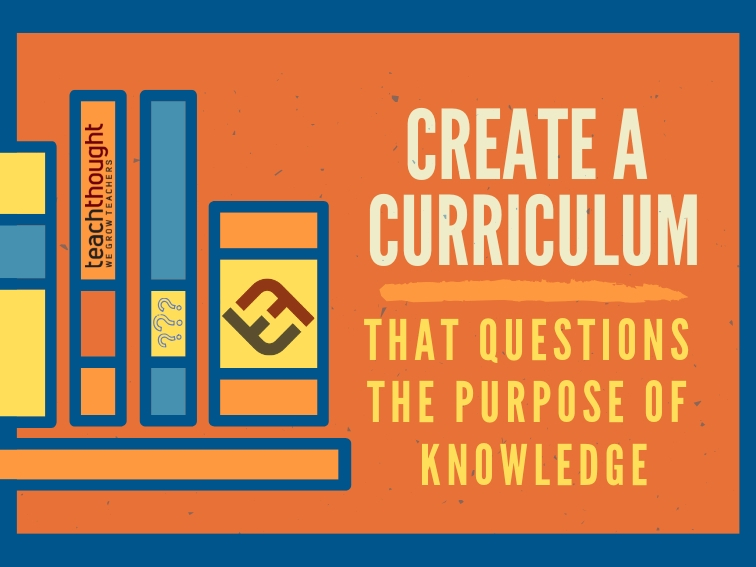بقلم تيري هيك
في تعليق قيّم على مقالتنا الأخيرة عن افتتان التعليم بالتماسك والمواءمة، طرح القارئ جيمس فوس فكرة مهمّة داخل نقاشه: “غرض المعرفة”.
هل هي المعايير التي تُوجّه المناهج، أم ممارسات التقويم التي تُحدّد طرائق التدريس؟
من الممكن أن يكون النموذج الموحد الحالي أفضل من المعايير المتفرقة التي طوّرها المربّون تاريخياً في مجتمعاتهم المختلفة، لا سيما إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية الصرامة وإمكانية مقارنة تقدم المدارس. ومع ذلك، من الضروري التأكيد على نقطة السيد هيك: المعايير الموحدة لا تلامس بالضرورة مستوى التوطين الذي تفضّله المجتعات الحيوية.
النكهة المحلية في مناهجنا يمكن أن تُغنى من خلال تركيبة الأفكار التي تشكّل المجتمعات، ومن خلال القيم التربوية الشخصية لدى المعلمين والإداريين الذين يضعون المنهاج، ومن خلال حوار صريح حول كيفية تطوير طرائق التدريس عبر التساؤل عن طبيعة المعرفة ومصادرها وأغراضها.
في الآونة الأخيرة، اعتلت طيف إصلاح المناهج المنابر التي يهيمن عليها الفاعلون الكبار. يمكن إعادة صياغة تعليق السيد ويجينز عن افتقار الخيال كسؤال أبزر: من يسيطر على الإصلاح؟ هناك دلائل على أن الأفراد، بمن فيهم المعلمون والإدارات المدرسية، قادرون على إظهار خيال كبير عندما يُمنحون السلطة والتمكين.
كلام سديد.
فكرة تستحق أن تُنقش على الجباه أو تُرسم على جدران ممرات مدارسنا: الحاجة إلى تعريف غرض التعليم أولاً وقبل كل شيء. ماذا نحاول أن نفعل، ولماذا؟ من دون هدف واضح، لا يحدث تقدّم حقيقي، بل مجرد حركة. فالتقدّم نسبي—هو تحرّك نحو شيء ما. لا يمكننا أن نعرف “كيف نحن الآن” حتى نعلم إلى أين نتجه، وماذا نخسر بعدم وصولنا إلى هناك.
ولا يُشكّل المنهاج وحده—ولا الإتقان في محتواه—جواباً شافياً.
المنهاج كمصنَع فكري
لنتفق أولاً على أن المنهاج هو ما يُدرّس—مجموعة من الخبرات التعليمية المخطّطة التي تهدف إلى إكساب المتعلمين معارف ومهارات متقنة.
تُفصّل تلك المعارف والمهارات ضمن معايير أكاديمية. بهذه الصورة، تشبه المعايير المكوّنات؛ والمنهاج المحضّر من تلك المكوّنات هو المنتج الناتج من ترتيبها وتغليفها في وحدات، دروس، ونشاطات.
(هذه الصورة مفيدة أيضاً لفهم كيف ينظر الطلاب إلى المعايير—لا أحد يريد أكل المكوّنات الخام؛ لا أحد يريد تناول الدقيق والملح والشوكولاتة منفصلة، لكنهم سيأكلون البراونيز.)
المنهاج هو بناء مؤسسي—شيء يصنعه الناس. لقد تعلم البشر لآلاف السنين من دون مناهج منظّمة؛ فوجود منهاج ليس شرطاً للتعلّم بحد ذاته، لكنه يصبح ضرورياً حين يتحول التعلّم من فعل فردي إلى منتج مخطّط ومنظّم.
هذا لا يجعل المنهاج سيئاً. هدف المنهاج توفير نقطة تجمع لكل شيء آخر، وتأسيس لغة مشتركة لفهم ونقل المعارف، ويعمل كإطار تفاهم مشترك. هذا ما نجتمع من أجله، كما أن جمهور الحفل الموسيقي يشترك في نفس الموسيقى وتوقّعاتها.
المنهاج كاستراتيجية
إذًا، المنهاج هو استراتيجية تعلم—أداة تُستعمل لتعزيز التعلّم. وكاستراتيجية (وبصراحة بقايا من طرائق التدريس التقليدية) يحمل في داخله الكثير الذي، عند فهمه خطأ، يجعل التطبيق غير فعّال للغاية.
مكوّنات أي “منهاج” تتفاوت بين موضوعات وأطر تمثّل هذه الموضوعات وُمهارات. تسعى المعايير إلى تحويل شيء غير ملموس (مثل الكفاءة القرائية) إلى شيء ملموس يمكن قياسه. لذا، إذا كان المنهاج هو المحتوى الذي يُدْرَس ويُتعلّم (والذي يُوزّع عبر طرائق تدريس وتعلّم تُقاس فعاليتها بواسطة تقويمات)، فإن ذلك يقدّم لنا وظيفة واضحة: هدفًا لمنظومة التعليم. من منظور وظيفي، هو السبّب الأولي للمدرسة. يعبّئ المنهاج المحتوى، ونتاجه المقصود هو المعرفة.
القفزة من المنهاج إلى المعرفة
لكن ماذا عن تلك المعرفة؟ هل تصبح المعرفة يقينية بمجرد إتقان المنهاج؟ وما غرض المعرفة؟ ماذا ينبغي أن نفعل بها؟
وليس “نحن” المجملة فحسب، بل ذلك الولد ذو التسع سنوات وتلك الفتاة ذات الأربعة عشر، وتلك مجموعة طلاب الصف النهائي في مقاطعة ريفية—ماذا ينبغي لهم أن يفعلوا؟
المنهاج يقرر أي معرفة، لكنه لا يجيب عن لماذا المعرفة. هذه المسائل عادة ما تُنسب إلى علم المعارف والفلسفة، وهذه هي المشكلة: هي قضايا بديهية تتجاهلها السياسات والتعليم الرسمي بتعجرف “نحن نعلم ما هو الأفضل للجميع”. يجب أن تكون هذه قضايا تُهم كل مربٍّ، وكل مدرسة، وكل إدارة.
ماذا نفعل بما نعرف؟
هذه مسائل تنطوي على الممارسة والتعبير الإنساني الجوهري—المنهاج واحتياجات من يدرسه.
ربما تكون القفزة من المنهاج إلى المعرفة مسألة تصميم: تصميم منهاج لا يهدف فقط إلى إنتاج طلاب يكتسبون معرفة جاهزة، بل إلى إنتاج طلاب يرفضون قبول المعرفة إن لم تُقدَّم لهم بطريقة تناسب جيوبهم وهواتفهم وخيالهم النابض.
حتى يعرفوا من أين تأتي المعرفة، وإلى أين قد تقودهم.
منهاج يسائل غرض المعرفة
صورة معدّلة: مستخدم فليكر tulanepublicrelations