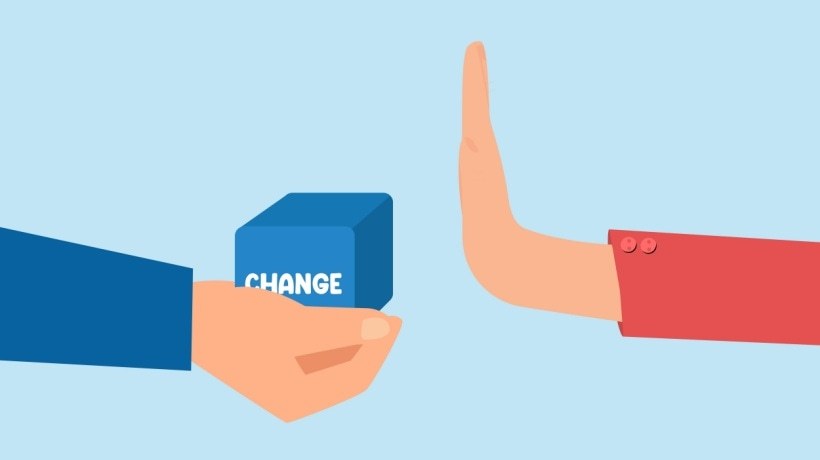الصورة تعكس واقعاً شائعاً في كثير من المنظمات: تمسك ببرامج تعليمية فاشلة رغم وضوح عيوبها. يمكن أن يكون “الحصان الميت” هذا برنامج استقبال الموظفين الجديدين الذي لا يؤهلهم للعمل، أو دورة امتثال لم تقلل من الأخطاء المهنية. وبينما قد يسهل علينا تمييز الفشل، تظل المسافة بين الإدراك واتخاذ القرار لإصلاحه أو استبداله أوسع بكثير مما نتوقع. فما الذي يعيق التغيير؟ وما الذي يدفع الشركات إلى ضخ الموارد في مبادرات تعلم ثبت عدم جدواها؟ هنا إعادة صياغة مركّزة لأهم الأسباب وتداعيات الإهمال.
التكاليف الخفية للاستمرار في استثمار برامج تعلم فاشلة
قد يظن البعض أن الثمن الوحيد للإصرار على برنامج تعليمي رديء هو الوقت الضائع، لكن الواقع أكثر تعقيداً:
– تآكل المشاركة: عندما تكون المواد قديمة أو سيئة التصميم، يفقد المتعلّمون دافعهم بسرعة. يهبط معدل المشاركة وتضعف مصداقية استراتيجية التعلم بأكملها.
– أثر مالي مباشر وغير مباشر: تحديث أو استبدال برنامج فاشل يبدو كتكلفة فورية، لكن الاستمرار في برنامج لا يحقق نتائج يؤدي إلى خسارة فرص ربحية وتراجع أداء الموظفين؛ استثمرات في أساليب حديثة—كالتعلم التجريبي أو المنصات الغامرة—تؤتي ثمارها بسرعة بتحسّن النتائج والأداء.
– تراجع القدرة التنافسية: التمسك بأساليب قديمة يحرم القوة العاملة من التكيّف مع تقدم التقنية ومتطلبات السوق؛ والمنافسون الذين يجددون طرقهم سيكسبون ميزة لا تُستهان بها.
– تآكل الثقافة المؤسسية: عندما يلاحظ الموظفون أن القادة يتجنبون القرارات الصعبة ويرحّبون بالركود، يتحول ذلك إلى سلوك عام—رفض الابتكار، تمسّك بالوضع القائم وممانعة للتغيير.
خمسة أسباب رئيسية لاستمرار الاستثمار في برامج تعلم فاشلة
الأمر أبعد من عدم رؤية النتائج؛ هناك اعتقادات وممارسات تغذّي هذا الإصرار.
1) مغالطة التكاليف الغارقة
«لقد أنفقنا كثيراً لنتوقف الآن.»
أكثر الحجج تكراراً هي حماية ما تم إنفاقه بالفعل: تصميم المحتوى، اختيار نظام إدارة التعلم، تدريب الموظفين، إلخ. لكن الأموال المنفقة سابقاً لا تبرر الإبقاء على نظام لم يعد يحقق الغاية. التمسك بالماضي يعيق النجاح المستقبلي.
2) راحة المألوف
«استخدمنا هذا البرنامج لسنوات، والجميع يعرفه.»
المألوف يوفّر شعوراً بالطمأنينة المزيفة. المعرفة بكيفية تشغيل النظام والتعامل مع أعطابه تولّد تكاسلاً: لا أحد يتجرأ على الطعن في فاعلية ما اعتُبر “مجرّباً”. ما يفتقر إليه هذا الافتراض غالباً هو جمع تغذية راجعة حديثة وقياسات نوعية تؤكد استمرار الجدوى.
3) عامل الخوف
«إن أوقفناه الآن، فماذا نفعل لاحقاً؟»
الخوف من الاضطراب الناتج عن تغيير النظام—خاصة حين يخدم عدة عمليات مثل الامتثال والتأهيل والتطوير—يدفع الفرق إلى وضعية الصيانة المؤقتة: تحديثات سطحية أو إعادة تصميم أجزاء معزولة بدلاً من إعادة بناء استراتيجية متكاملة. هذه الحلول الجزئية تبقى ترقيعاً لا معالجة جوهرية.
4) التركيز على مقاييس خاطئة
«انظروا كم عدد العاملين الذين أكملوا الدورة!»
الاعتماد على مقاييس كمية بسيطة—معدلات الحضور، نسب الإكمال، استبيانات رضا سطحية—يخلق وهماً بالنجاح. المؤشرات الحقيقية تقيس التغير السلوكي، تطبيق المهارات في مكان العمل، والتأثير على أداء المنظمة. غياب التركيز على هذه البيانات النوعية يمنع رؤية الفشل الحقيقي.
5) الصلابة الثقافية
«هكذا نفعل الأمور هنا.»
أحياناً يكون جذر المشكلة ثقافياً: تمسك بالتقاليد، هياكل بيروقراطية معقدة، وخوف من تحدي أصحاب القرار. في هذه البيئات يحتاج أي تغيير إلى جهد هائل لتجاوز مقاومة المؤسسات والعمليات الراسخة، ما يجعل ركن الابتكار أضعف.
خلاصة
استراتيجية التعلم والتطوير الناجحة هي تلك التي تتطور باستمرار استجابةً لمتطلبات الصناعة وحاجات المتعلمين. فهم الدوافع النفسية والسلوكية التي تمنع ترك البرامج الفاشلة يمكّن القادة من كسر دائرة الإنفاق غير المنتج—وتحرير الموارد لإجراءات تحديث حقيقية تحقق فائدة ملموسة للمؤسسه وتعيد الحيوية لثقافة العمل.